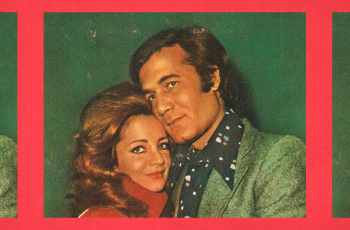دكتور شفيق
ما أن وصلني الخبر حتى سارعت لفتح واتساب بحثاً عن اسمه، تمعنت في آخر الرسائل بيني وبينه، بقيت أنظر ببلاهة للمحادثة، أنتظر رنة وصول رسالة، سطراً جديداً، كلمة ما تجذبني من كابوس الخبر وتجذبه من الموت، ليعود د. شفيق، فيطمئنني بكلماته القليلة وضحكاته الهادئة الرصينة ومزاجه الرائق، دوماً رائق هو مزاج الدكتور شفيق.
لكن الموتى لا يعودون، والموت النذل لا يفك أسر أي من مساجينه، هذا الموت الحاقد الذي يختار أفضلنا ليبدأ به ثم لا يُبقي أحدا، ولا حتى أسوأنا.
المغادر اليوم رجل مميز، مفكر وباحث وناقد وأكاديمي يعرفه العالم العربي من شرقه إلى غربه والعالم أجمع من أميركا إلى آسيا، لذلك، لا يصح تقديم د. شفيق ناظم الغبرا، فاسمه يقدمه، مؤلفاته تؤرخ عمله، جوائزه ومناصبه توثق رحلته، ومشاركاته التي لا تعد ولا تحصى في المؤتمرات والندوات والمقابلات تحكي عن سيرته ومسيرته.
كما لا يصح أن تكتب أي مادة بعد فقده عن علاقة الآخرين به، فأكثر المنفر هي تلك المقالات والمقولات التي تحول الفقيد الشهير، أي فقيد شهير، فجأة إلى صديق عزيز لكل متحدث عنه، ليتباهى بصداقته المتباهون، ويتعالى بمعرفه أسراره المتعالون، وليكسبوا لحظة أهمية مسروقة تحت بقعة ضوء الفقيد، دون أن يعرفوا أنه برحيله أخذ الضوء معه، ليبقى كل الكلام الخاوي كذلك، خاو وفي ظلام دامس.
ربما أنا أغامر، بكتابة هذا المقال، بأن أقع في ذات الفخ الكريه الذي أصفه، لكنني غير قادرة على عدم الكتابة، غير قادرة على السكوت بعد وفاة الدكتور الفلسطيني الكويتي شفيق الغبرا. سيكون هذا المقال عن علاقتي أنا به لا علاقته بي، وسيكون هذا المقال تنفيساً لصدري لفقد لا يعوض لا نعياً دعائياً متباهياً بعلاقة لا فضل ولا خصوصية لي فيها.
أنا فقط واحدة من معارف الدكتور الكثيرين، وهو أحد أهم الرموز الأكاديمية المفكرة في حياتي، لذلك لا يحكي هذا المقال عن أهميتي في حياة الدكتور، فلا أتصور أن كانت لي تلك الأهمية مطلقاً، ولكن عن أهميته هو في حياتي، التي كانت أهمية ثقيلة وكبيرة ومؤثرة لأبعد الحدود.
لا أتصور أن الدكتور شفيق نال حقه في حياته، خصوصاً في السنوات الأخيرة حين ارتفعت النبرة الخانقة التي قسمت المجتمع الكويتي إلى حد كبير على نفسه.
ذات زمن، وقفت نائبة في مجلس الأمة الكويتي تعاير الدكتور شفيق على تجنسه، تمن عليه بالهوية الكويتية، ليعلق هو باسماً “ما علينا، لا يجب أن نعطي الكلام أكثر مما يحتمل”، ذات زمن رفع أحدهم، لا أحد يذكر شخصه أو اسمه، قضية على الدكتور بسبب كتابه “النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت”، ليبدي هو، رغم ضيقة قلبه بسبب هذا الموقف، تفاؤله وثقته بإنصاف القضاء، وهو ما كان.
ذات زمن قيم الدكتور المعارضة في الكويت بحكمة وإنصاف ودعا للاهتمام بما لديها في حين لم يستطع “الصغار” سوى أن يروا في نقده فلسطينيته، ووضعوها “تهمة” بينه وبين بلده الكويت، ليؤكد هو فعلاً قبل قولاً أن كويتيته هي منبع كل آرائه.
وكويتية الدكتور هوية صافية رائقة، معجونة بعصرة زيتون فلسطينية طازجة، لتصنعه هو: كويتي يتحدث اللهجة الفلسطينية، فلسطيني يعيش كل تفاصيل حياته بكويتية خالصة، أكاديمي رصين حياته منذوره لأروقة الجامعات، مناضل عريق تاريخه مزدحم بالبنادق والسلاح.
لم أعرف في حياتي شخصية كالدكتور شفيق، لولا كتبه لما تخيلت هذا الهادئ الباسم رقيق المعشر مناضلاً مسلحاً، ولولا معرفتي الشخصية به لما تخيلت هذا الشاب المناضل المسلح الثائر المحارب الموصوف في كتابه “حياة غير آمنة” أكاديمياً هادئاً.. الدكتور شفيق كان نقيضين، أفضل ما على طرفي القطب الإنساني، وهو الآن، اليوم، غير موجود.
إبان سفره كان أكثر ما حدثني عنه، حين سمح لي بالتواصل، هو السياسة الأميركية والوضع الداخلي الفلسطيني، يتكلم بأكاديمية وعلمية ومنطقية أكاد استشعر جمرها كلها مخبأً أسفل هدوء الكلمات.
يسألني عن الجديد في الكويت، فأحكي عن مجلس الأمة والنواب، أسهب حول قضية البدون، فيصمت تماماً مستمعاً، ثم يرد على تساؤلاتي للاطمئنان عن صحته بتلك الموضوعية والعلمية والحياد الذين لا يقدر عليهم سوى أكاديمي رفيع كالدكتور شفيق.
ما تغير شيء في روحه ونفسه، بقيت نبرته المرحة وضحكته الرصينة وموضوعيته المطمئنة، مهما كانت وعورة الموضوع محل الحوار، كلها تسود الحديث وتغلف التواصل.
بقي الدكتور مجرد شاهد على مشهد مرضه، كأنه يخبر عنه ولا يعيشه. لربما اعتقد الدكتور أنه كان يريح من أمامه بقوته، كما اعتقدت أنا أن رد الفعل الأخلاقي هو أن أبادله قوة بقوة ولا مبالاة بمثلها. بدا لي وكأننا كنا نتكلم عن مرض شخص آخر ليس هو، كان قاسياً على نفسه في موضوعيته، وكان قاسياً علي وهو يجبرني، لربما كما أجبر كل واصليه، بلباقته وهدوئه على احتمال هذا الكلام المنطقي العلمي بلا ردة فعل طبيعية، ولربما كنت أنا أيضاً قاسية وأنا أمثل دور الموضوعية الهادئة. ليتني أخبرته بالخوف الذي كان مستبداً، تراه كان يسمح لي؟
والآن رحل، بلا ضجة، بلا كلام. عملي الدكتور شفيق دائماً، في حياته، في تعامله مع مشاكله، وفي رحيله. لربما نضاله الفلسطيني دربه على هذه العملية، لربما البعد والشوق للوطن علماه ضبط المشاعر بالمسطرة، لربما التحامه بالوطن الحالي والغوص في أعمق أعماقه علماه التأقلم والتقبل والحب غير المشروط. حياته الثرية العميقة المليئة بالنضال والبحث والتفكير ثم بالحب الغائر للفنون والآداب والجماليات، جعلته المتناقض الأروع، المتنوع الثابت، المناضل المسالم ورجل السلام الثوري. كلها تناقضات الدكتور شفيق الرائعة، أخذها كلها معه راحلاً دون ضجيج.
أعلم أن لا ذنب له في الهدم الذي أستشعره الآن، لم أكن وجوداً هاماً في حياته، لكنه كان صديقي ومعلمي الأهم، فماذا أفعل بكل ما أشعر الآن؟ كيف أتعامل مع ما تبقى في الروح؟ لست موضوع المقال، أعلم ذلك وأتذكره، ولكنه رحل وأنا الباقية، فماذا أفعل بكل هذا الغضب والحزن والفراغ؟