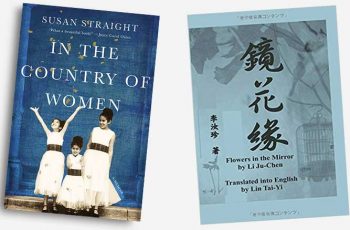متلازمة نفسية
تقلبت ليلة أمس في فراشي حتى الثالثة فجراً، داهمتني أفكار بدت عامة جداً وقد انقلبت لتأخذ منحى شخصي ثقيل في نفسي. تذكرت مقال لمعلم من أحد الدول العربية كنت قد قرأته في بدايات أزمة كورونا وذلك بعد مرور بعض الوقت على إطلاق عملية التعليم الالكتروني والتي سبقت دول عربية عدة الكويت إليها. كنا بعد ما بدأنا التعليم الالكتروني في الكويت، مما دفعني لقراءة مقال المعلم الزميل بنصفي عين، نصف متعاطف معه ونصف آخر ناقد لما تصورته مبالغات منه خصوصاً حين أعلن تقاعده العمل التعليمي بعد تجربة التعليم الالكتروني.
ولقد كانت معضلة الغش قائمة في معظم المؤسسات التعليمية العربية، ومؤسسات الكويت ليست باستثناء، بل ان الوضع استفحل عندنا داخليا لحد خروج الصحف المحلية بعناوين رئيسية مشيرة إلى أن كارثة الغش هي أحد أهم العوائق التعليمية المحلية، ثم لتتثبت هذه الصورة بعمقها وخطورتها الحياتية والأخلاقية حين خرج مجموعة من أولياء الأمور عندنا في الكويت معتصمين ضد إجراءات وزارة التربية تجاه الطلبة الغشاشين، مطالبين بمراعاة “عيالنا” والأخذ بعين الاعتبار أن “الجميع يغش”.
لا تختلف الكويت عن بقية العالم العربي في هزيمتها أمام طغيان مفهوم “الغاية التي تبرر الوسيلة”، في هزيمتها في مواجهة هدف “أفضل النتائج بأقصر الطرق، أياً كانت هذه الطرق.” تتندر الأمهات (وأحياناً الآباء إذا ما شاركوا في التربية التعليمية) بانشغالهن بالدروس أكثر من الأبناء، حيث تؤدي هذه الأمهات أغلبية الامتحانات الالكترونية لتأتي نتائج أبناءنا في العالم العربي جميعاً خلابة، لقد انقلب “كل العيال” بين ليلة وضحاها لتلاميذ نجباء. إنه سحر الكورونا العجيب، يضرب الجهاز التنفسي من جهة ويحيي الجهاز العقلي من جهة أخرى.
أما في الجامعات، فقد انتشرت الأوراق المزورة والأبحاث المنقولة والامتحانات المغشوشة، وتفنن البعض في إيجاد وسائل “لأقصر الطرق”، حيث ظهرت وظائف جديدة في هذا الإطار مثل وظيفة “طالب حضور” ووظيفة “طالب ممتحن” ووظيفة “مرافق لطالب” وغيرها من “وظائف” فتحت الكورونا بتعليمها الإلكتروني الباب أمامها. لقد سَمَت بنا أزمة الجائحة كبشر من ناحية كما كشفت عوراتنا الأخلاقية من ناحية أخرى، أظهرت أفضل تعاضداتنا الانسانية وأسوأ انتهازياتنا وفقرنا الأخلاقي، والتي أخطرها بكل تأكيد ما يتجلى في المجال التعليمي.
أحاول أجد بعض الأمل، أو أن أجدده، أن أجتره من سنام ذاكرتي، لكن لا شيء يجدي وأنا أدقق ورقة بعد ورقة، امتحان بعد امتحان، واجب بعد واجب لأكتشف ليس المستويات العلمية والثقافية للطلبة، ليس فهمهم الأدبي والفني للمادة المطروحة، ليس مقدار مهاراتهم الكتابية والتحليلية والنقدية، ولكن لأكتشف، في عدد حالات أكبر مما يجب أن يكون، أساليب خارقة الذكاء في نقل المعلومة وترصد المواقع الانترنتية الخفية والاستعانة بالمساعدات الخارجية كمكاتب البحوث التي أعتبرها، دون أي تعديل أو تخفيف للتعبير، دور بغاء عقلي. طبعاً اكتشاف تلقي الطالب المساعدات الخارجية هو المهمة الأصعب، حيث يتسنى هذا الاكتشاف بعد فترة من معرفة الطالب واختباره شفهياً وكتابياً في مواقف ومواقيت مختلفة. وكما يتحايل الطلبة لنيل الدرجة، نتحايل نحن لكشفهم، لتتحول العملية التعليمية من مساحة بين طلبة وأساتذة في محيطات علمية جادة راسخة هدفها الثقافة الحقة، إلى حلبة ملاكمين يداورون ويناورون، والغلبة للأكثر دهاء.
لقد ترددت كثيراً في كتابة هذا المقال، فالإشارة لمؤسساتنا التعليمية، الأهم والأرفع والأخطر بين كل مؤسسات المجتمع المدني، هو فعل كتابي غاية في الحساسية لا يجب أن يتم إلا بحساب. ولولا أن الوضع تدهور بشكل غير مسبوق، ما كنت لأتناول هذا الموضوع المؤلم الذي ظهر تحت أسوأ الظروف، ظروف كشفتنا كمعلمين قبل الطلبة: ماذا كنا نعلم أجيالنا القادمة كل هذا الردح الماضي من الزمن؟ أي كود أخلاقي زرعناه فيهم؟ أي تجاهل وتقصير واستخفاف بدو منا حتى يصل الحال لما آل إليه؟
نحن، كمعلمين وأكاديميين، نتحمل القدر الأكبر من المسؤولية بلا شك، لذا دعوني أرفق الاعتذار باعتراف. بلا شك، الطريق القصير مغري، مغري من حيث سهولة قطعه واجتيازه، ومغري من حيث سهولة تبرير اللجوء إليه، ومغري من حيث سهولة إقناع النفس أنها “مرة وتعدي”، بل أن أشد درجات إغرائه تتجلى في شهودكم بحد ذاتكم لتبني الأجيال السابقة له علنا، بلا حياء، وبلا تداعيات أو عقوبات تذكر. بل إنني أتفهم تماماً عدم وضوح فساد هذا الطريق فعلياً، عدم القدرة على تمييز خرابه الأخلاقي، وهذه ضبابية أجيالكم السابقة مسؤولة عنها تماماً.
لكن رغم كل المبررات، واقع الحال يا صغار أن كل الفساد الذي تشكونه وكل المعاملة التمييزية “الوسائطية” التي تعانون منها وكل استحقاقاتكم المهدرة وكل مهاراتكم غير المقدرة إنما يقبع خلفها أشخاص أخذوا خطوة مبررة في طريق الفساد، خطوة أسروا لأنفسهم أنهم صغيرة وبسيطة ومفردة، خطوة سرعان ما جرّت خطوات وخطوات حتى أصبحت قصة حياة فاسدة كاملة لصاحبها ولكل من يعرفه أو يتعامل معه. تذكروا يا صغار أن كل فاسد تنتقدونه وكل نصاب تسخرون منه وكل متحايل تذمونه، كان ذات يوم شاب أو شابة ذوي طموح، سمح لنفسه أن ينزلق مرة، وبرر لنفسه أن يتساهل أخرى، وسوغ لضميره أن يصمت أخرى وأخرى، ليصل سريعاً وعالياً، وليتحكم بكم ويهدر حقوقكم.
يمكن لكم أن تستكملوا هذه الدائرة البشعة المريبة التي تملأ المجتمع بالفاسدين، ويمكن لكم أن تقولوا لا، سيقف هذا الدوران الأحمق هنا.. عندنا. لا أقصد هنا أن أحملكم مسؤولية الإصلاح بأكملها، لكنني بالتأكيد أحملك إمكانيته، الأجيال السابقة المعجونة في مفاهيم الفساد لا أمل في إنقاذها، الأمل اليوم بكم ولكم.
أعلم أن المقال يحمل طعم المبالغة، إلا أن الحقيقة أنه لا مبالغة مطلقاً هنا. لقد تحول الوضع التعليمي في المنطقة إلى متلازمة نفسية، ناحياً إلى مناورات خطرة أخلاقياً لا تمت للمحيط الأكاديمي بصلة. أقر أن الطواقم التعليمية العربية كلها وفي كل المراحل التعليمية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، فهي وإن لم تخلق مفهوم “الغاية تبرر الوسيلة”، وهي وإن كانت ضحية أخرى للظروف السياسية وما خلقته من تناقضات أخلاقية في المنطقة، إلا أنها لم تقاوم كما تستوجب المقاومة من المعلمين والأكاديميين وصناع الرأي في المجتمع. لقد كشفتنا الجائحة وعرت الطريقة الحقيقية التي نفكر بها ومستوى الالتزام الأخلاقي الذي يمكن أن نتمسك به حين تختفي المراقبة التقليدية ونترك لضمائرنا. لابد من التعامل مع القضية بجدية قصوى ومحاولة خلق حلول فاعلة وفورية للتعامل مع معضلات المجال التعليمي. إذا انهزم التعليم بالكامل، ستكون تلك هي النهاية.