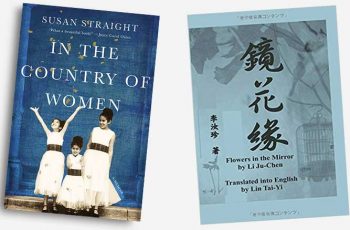ذات ليلة صوفية
بعد أن أمضينا ليلة رائعة وبديعة في منزلهما، بصحبة فرقة عود جميلة احتفاء بعيد زواجهما الأربعين، أرسلت صاحبة الحفل تشكرنا على الحضور ونشكرها الدعوة والكرم والصحبة الممتعة. أشارت ضاحكة إلى حاجتنا جميعاً إلى مثل صحبة تلك الليلة وإلى متعها الموسيقية الغنائية الرائقة، إلا أنها مرت بتلميحها على تدينها، معلقة بنبرة لا تخلو من الشعور بالذنب أنها رغم هذا التدين فإنها لم تكن قادرة على منع انطلاقتها وفرحتها. أرسلت لها أقول: «وهل في تدين وإرضاء لله أجمل وأصدق من إدخال الفرحة على قلوب الآخرين؟ في شيء أكثر صفاء وأخلاقية من تجميع الأحبة وإفراحهم وإعطائهم ساعة أو ساعتين إجازةً من مشاكل الدنيا وهمومها؟ الموسيقى صفاء للنفس، والرقص تنفيس مثله مثل أي ممارسة تأملية أو رياضية، والكل كان صافي النية والضمير، فهل أحلى من ذلك؟ هذه هي قمة التدين والأخلاق».
وقع تعليقي موقعاً حسناً من نفس محدثتي والحضور على الـ «جروب» التلفوني الذي يجمعنا، إلا أن الموضوع أثار في نفسي تعاطفاً شديداً مع حالة تأنيب الضمير التي يتعايش معها عادة المتدين تقليدياً، حيث دوماً ما يبدو له الفرح مغامرة أخلاقية والحزن والألم فرصة لاكتساب الثواب، فنحن في مجتمعاتنا نتوجس خيفة من ضحكنا السعيد مثلاً لنتبعه دوماً بجملة «اللهم اجعله خيراً» حيث تبدو لنا السعادة جلابة للنحس ومتع الدنيا مدعاة لارتكاب الآثام، حتى بات اكفهرار الوجه مرتبطاً بالجدية والتدين. وعلى حين أن الكثير من التعاليم الإسلامية تحث على البشاشة والابتسام في وجوه الآخرين، فإن الكثير من الممارسات الحياتية يصحبها التجهم دلالة على الجدية والالتزام، وهو ما يشير في رأيي إلى شعور مستمر بتأنيب الضمير تجاه أي شعور بالسعادة، وكذلك إلى استقرار فكرة أن المعاناة في الدنيا ومنع النفس عن مباهجها هما مصدر ثواب الخالق ورضاه، وهي الفكرة التي تخلق هذه الأزمة النفسية بين رغبة الإنسان في متع الحياة وخوفه من الخروج عن حدود الخالق كما يفهمها هو.
كانت ليلتنا عائلية حميمة بحتة، ملأتها أنغام أم كلثوم ووردة، ليلة لم تخل من الأشجان تجاه أهل لبنان والعراق وإيران ومصر والدعوات لهم كلما عزفت الفرقة أنغام أغنية قادمة من نواحي هؤلاء الجيران الأبطال، الذين رغم معاناة شعوبهم التي نستشعرها ورغم نضالهم المضني الدموي الذي نشهده ورغم قربنا الثقافي والجغرافي منهم، تستمر حياتنا خارج دوائر حيواتهم الخطرة بطبيعتها، فنعيش نحن جيرانهم حياة طبيعية رغم ما يعانون من مشاق ومخاطر، نعيش ناسين أو متناسين، إنها سنة الحياة الغريبة التي تجعلنا جميعاً نتماهى فيها رغم ما يمر به أبناء جنسنا خلالها. لربما كان هذا موقع التأنيب الأكبر في قلبي، لربما تقتُ لأن أغني وأرقص مع المناضلين في ساحات نضالهم، ولربما كان هذا التوق ميسراً، إن لم يكن منافقاً، لمن تعيش في أمان، يظللها سقف وتتوفر اللقمة على طبقها. لربما كل حياتنا مجموعة من التناقضات والنفاقات التي هي وسائلنا الوحيدة لأن نستمر في هذه الحياة بكل غرابتها وأنانياتنا، لربما هو كل ذلك، ولكن.. ورغم كل هذا التناقض والنفاق، كانت مشاعر تأنيب الضمير حقيقية وإن عجز الفعل عن متابعتها.
كنتُ متناقضة، متذبذبة بين فرحتي وتأنيب ضميري، بسبب فرحتي واستمتاعي بوقتي، فيما أبطال من نساء ورجال يموتون كل يوم على مرأى ومسمع منا من أجل حرياتهم، وكانت هي متناقضة ومتذبذبة بين فرحتها وتأنيب ضميرها بسبب فرحتها التي فتحت عليها مداخيل الشيطان غناء ورقصاً بين الأهل والأحباب. كلنا في الشعور بتأنيب الضمير بشر قاصر، لكنني وددت لو أقنعتها أني أحق بهذا التأنيب، أنني المذنبة الحقيقية وهي الصافية الرائقة، فأن تكون واعياً بفرق نوعية الحياة بين تلك التي لك وتلك التي لغيرك وتستمر تعيش هذه الحياة فأنت، بلا شك، تعيش حالة نفاق ولا مبالاة واضحة، أما أن تفرح في حياتك وتأتي متعها الصافية الإنسانية الطبيعية، تغني بين أحبابك، تراقصهم، تحتضنهم وتقبلهم، تلمس أياديهم، تنظر في عيونهم، فأنت تعيش حياة صافية طيبة لا نفاق فيها ولا تناقض. كيف يمكن لتلك التبادلات الإنسانية الشفافة أن تكون حراماً، كيف يمكن لهذا التواصل النفسي والحسي أن يكون مدعاة غضب الخالق، كيف يمكن أن تصلك نار لأنك فقط رقصت على أنغام موسيقى أو احتضنت إنساناً عن محبة نقية خالصة؟
ليتها استشعرت كم كانت نقية صافية القلب فعلاً، كم قدمت لنا ليلة صوفية تحررنا فيها من كل همومنا، وإنني أنا التي كنت مذنبة مثقلة، أعرف ما أعرف، أتجاهل ولو لزمن، وأستمر. ليتها استمتعت أكثر وخففت عن نفسها من مشاعر الذنب، وهل الفرح والحب مدعاة شعور بالذنب وتأنيب الضمير؟