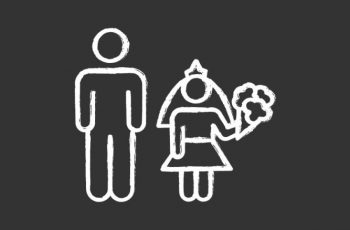دائرة السكون
أتمنى أحياناً أن أكتب الألم، أشكله حروفاً وكلمات وجُملاً، أزينه بالفتحات والضمات والشدّات ودوائر السكون الجميلة الخارقة، أجمل علامات التشكيل العربية وأكثرها تعبيراً عن اللانهائية والعدمية في كوننا السحيق، علّ كل هذا الألم يخرج من صدري ويرقد بسواده على الصفحات البيضاء، فيمنحني فترة راحة ويسكن روحي بدقائق حداد وأنا أدفنه في بياض الورق. لكن الألم لا يُكتب، عصي على الأحرف والكلمات، متعال على التعابير المتعارف عليها، متفاخر بأصالته ونبله اللذين لا يمكن أن تصورهما لغة. اللغة قاصرة أمام الألم، هي قاصرة عموماً أمام كثير من تجاربنا الإنسانية التي تتعدى كلمات وتعابير اللغة، إلا أنها حقيقة عاجزة أمام الألم، لا هي قادرة على التعبير عنه ولا هي متمكنة من تغطيته بتعابير تَجُبه. الألم يهزم اللغة، أي لغة، دائماً وأبداً.
حين مررنا بتجربة الألم أنا وهو معاً، ومن رحمة القدر أن أطعمنا المرار معاً ومن الملعقة ذاتها، بدونا عاجزين عن الكلام، معطوبي اللسان، مكسوري الروح، غير قادرين على تشكيل الألم في صوت يخرج على شكل كلمة أو جملة، غير قادرين على التعبير عن التجربة سوى من خلال العيون المغرورقة والنظرات الحزينة الكسيرة. أعلم ما في قلبه من ألم، وأستأنس بمحاولته اللطيفة لإخفائه، كأنني أشاهد فيلماً متواضع الصنع، ممثله غير قادر على إقناع مشاهديه مطلقاً. نلتقي أحياناً في منتصف الغرفة فيحتضن أحدنا الآخر، أشعر ببرودة أصابع يده وبحرارة جلد صدره البازغ من دشداشته، فأشد نفسي إليه وكأنني أحتمي به من نفسي، من أفكاري، من روحي المحروقة في داخلي، فيترك هو جسده الفارع يظللني، ثم يتباعد مبتسماً في وجهي، فأعيد ابتسامته بأخرى أظنها أحسن منها. وهكذا يسأل أحدنا الآخر صامتين: هل أنت بخير؟ نعم، أنا كذلك… وأنت؟ أنا بخير دامك بخير. مشهد حزين هذا الذي يواسي فيه أحدنا الآخر وهو مكسور القلب، متوجع الروح، مشهد يدق ضميري دقاً وأنا أتساءل، ألا يكفيه ألمه حتى يتحمل فوقه ألم التمثيل ومسؤولية المواساة؟
للألم هيبة ورهبة تجعل الإنسان أكثر وقاراً وأعظم جاذبية، إلا أن شعور الألم لا يتوانى عن ابتكار مجموعة من الأفكار في العقل، والتي قد تبدو غريبة أو عصية على الربط. منذ أن حل الألم بقلبينا وأنا أتساءل، ألم يكن يستحق شريكة أفضل قادرة على أن تكفيه هذا الشعور الحارق، قادرة على أن تمنع عنه هذه التجربة المريرة؟ اعتذرت منه ذات جلسة بشكل غير مباشر عن سماحي للأقدار أن تسقيه شيئاً من الألم فيما أنا معه، في بيته، شريكته أمام هذا القدر القاسي، فنظر إليّ وقد اتسعت عيناه الرائعتان باستغرابه: كيف وصلت لاستنتاج تلومين من خلاله نفسك على تجربة لم يكن لك يد فيها؟ في عمق قلبي أشعر أن لي يداً، إن لم تكن لي يد في صنع الألم فلي يد بالسماح بمروره، ويفترض أن تكون لي يد في منعه. نجحت في الأولى، وفشلت في الثانية، وما بقي لي سوى أن أجلس ناظرة إلى وجهه، بوسامته وبياضة شعره الذي بدأ يتفوق على سواده، واتساع عينيه المكحلتين طبيعياً، ورعشة يديه الوراثية وهي ترتفع حاملة السيجارة اللعينة إلى شفتيه، وأفكر، أي خير فعلت لأستحق وجوده في حياتي، وكيف سمحت للألم أن يقترب منه؟
يمر الوقت ويخفت الألم وتتحول التجربة إلى ذكرى نسترجعها أحياناً لنحاول فهمها، ونتفاداها أحايين تظاهراً بعدم المرور بها، ونتساءل دوماً، ولا أتصور أحدنا وقد مرت عليه سنون الألم الحادة ولم يفعل، لماذا هذه التجارب الحارقة، أي استفادة يستفيدها الكون من ألمنا، أي معنى لوجعنا في هذا الكون السحيق العدمي الذي سينتهي ذات يوم مبتلعنا كأننا ذرات غبار لا تُرى دون أن يندم على إيذائنا، دون أن يعطي للمعاناة معنى أسمى أو للوجع نتاجاً حقيقياً، دون أن يُنصَف المتألم وينقضي الألم وينسدل الستار الأخير على مشهد سعيد؟
أتسلل أحياناً إلى ورشته، أختلس النظر إليه وهو يمعن قطعاً وحفراً وتشكيلاً في أخشابه، أتجسس، وها أنا أعترف، على مكالماته واقفة خلف بابه لأتأكد من خفوت الألم وعودة الرضا، ثم أتذكر أنه لم يظهر لي ألماً ولم يفترق عن الرضا، سمح متسامح، راض مَرْضي، كأن روحه تعادل عدمية وعبثية هذا الكون، كأنه يواجههما برضاه وبخطته المنظمة بالتحدي الهادئ، كأنه يغيظ الكون بعدم التفاعل مع سخافاته وإيذاءاته العشوائية، تضرب دون معنى أو هدف. ترضى روحي برضاه، وتهدئني ابتسامته، وأقول سيكون كل شيء بخير، وأنا أعرف تماماً ألا ضامن للخير هذا أبداً حتى ولو كنا نمشي على أكثر الصرط استقامة في هذه الدنيا. أعرف أن عبثية الكون قد تضرب في أي لحظة، لكنني أعود لأختبئ بين يديه، في ظل طوله الفارع، في طيات ابتسامته، في رنين كلماته التي يطيب بها خاطري، أحمل معي شكل يديه ورائحة جلده و»تون» صوته، فيطيب خاطري وتهدأ روحي إلى حين.
ترى، لماذا يصنع الكون إنساناً مثله ثم يؤذيه؟ أي عبثية هي تلك؟